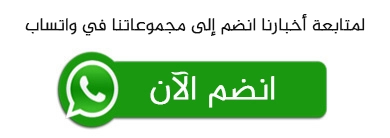كثيراً ما أتساءل ما هو العامل الحاسم والعنصر المهم في جعل بعض الأقوال أقوالاً حية، وذات قيمة على غيرها؟ أهي بلاغة التعبير أم صدقه أم قائلها أم المناسبة أو المحفل الذي قيلت فيه؟
دارت في ذهني هذه التساؤلات وأنا أطالع كتاب “فرنسيس بيكون: مجرب العلم والحياة” لمؤلفه الأستاذ عباس محمود العقاد والذي حوى مختارات من أقوال هذا المفكر الفيلسوف ورجل الدولة الذي عاش قبل حوالي خمسة قرون. ترى ما الذي جعل العقاد يقدم للقارئ أقوال هذا الرجل بعد حوالي خمسمائة عام من صدورها؟ وما الذي يجعلني أقتبسها لأقدمها اليوم للقارئ؟ دعونا نلقي نظرة على هذه الأقوال أولاً قبل الإجابة على السؤال.
قسم العقاد أقوال “بيكون” إلى ثلاثة أقسام: مقالات، ومتفرقات، وطرائف وإجابات. فمن مقالات “بيكون” نقتطف الآتي: رعاة الشعوب أحوج الناس أن يعرفوا علامات العواصف التي تهب على الحكومات. وللدول علامات قبل هبوب العواصف عليها، كتلك العلامات التي تشاهد في انطلاق الهواء وجيشان الماء قبل هبوب الأعاصير. ومن تلك العلامات شيوع الحملات والمثالب التي ترمى بها الحكومات، ووفرة الإشاعات التي تحوم حول الحكومات وتتلقاها الأسماع بالقبول السريع. وقد قيل في الإشاعة أن الأرض أوغرها الغضب على السماء فأخرجت الإشاعة من جوفها، فكانت آخر الذرية.
كأنما الإشاعات بقايا فتن مضت، وهي في الحقيقة طلائع فتن ستأتي من عالم الغيب. والإشاعات والقلاقل لا تختلف فيما بينها إلا كاختلاف الشقيقة من الشقيق والذكر من الأنثى، ولا سيما حين يصل الأمر إلى الحد الذي يساء فيه الظن بأجمل أعمال الحكومات وادعاها إلى الرضى والثناء.
تقول الأسطورة أن الأخوين بروميثيوس وابيمثيوس تعاونا على خلق البشر، فخلقت الآلهة “باندورا”، أول أنثى إنسانية على سبيل الانتقام منهما، فرفضها بروميثيوس وقبلها أخوه ابيمثيوس وتزوجها، فأرسلت إليهما الآلهة بهدية عبارة عن وعاء خشبي (حُقْ) مغلق رفض ابيمثيوس فتحه ولكن باندورا استغفلته وأزالت الغطاء عنه لتنظر ما فيه فطارت منه الشرور جميعاً، فسارع ابيمثيوس إلى إغلاقه ووجد أنه لم يبق في قرارة الحق سوى الأمل. ومما لا مراء فيه أن استخدام السياسة في محاولة تغذية الآمال وحمل الناس من أمل إلى أمل هو خير ما يتخذ ترياقاً مانعاً لسموم السخط والشكاية، وآية من الآيات على حسن تدبير الحكومة وسداد تصرفها، فتستولى على قلوب الرعايا بالرجاء والأمل.
من الحيطة الحسنة والوقاية النافعة ألا يكون ثمة رأس صالح لاتفاق الناس حوله للالتفاف به في أيام السخط والشكاية، ونعني بالرأس الصالح من له عظمة وسمعة، وللساخطين به ثقة وأمل، فيتطلعون إليه وهم يعلمون أنه مثلهم ساخط من أجل شؤونه التي تعنيه.
أمثال هؤلاء الرجال إما تستميلهم الدولة وتسترضيهم جداً وحقاً، وإما أن تقاومهم بنظراء لهم في الجماعة فيقسمونها عليهم. وعلى الجملة لا تعد الحيلة في تفريق الطوائف التي تعادي الحكومة وإقصاء نفوذها وبث الوقيعة بينها محاولة غير محمودة عند الضرورة المويئسة، وهذه الضرورة هي ابتلاء الحكومة بالشقاق في أعمالها وملاقاتها لخصوم متساندين بينهم متفقين عليها.
من المتفرقات نذكر أن بعض الأقوال اللاذعة البراقة التي يلفظ بها الأمراء كثيراً ما تلهب نيران الفتن والقلاقل. فقيصر قد أضر بنفسه غاية الضرر بقوله عن سولا إنه “لا يعرف الكتابة ولذلك يملي إرادته”، لأن هذه التورية قد أيأست الناس عن تخليه يوماً من الأيام عن سلطان الاستبداد، وأساء قلبا Galba إلى نفسه حيث قال إنه “لا يشتري جنوده ولكنه يكتبهم”، فأيأس منه الجنود وأمثالهم.
على الملوك في الأيام الحرجة والمسائل الحساسة أن يحاسبوا ألسنتهم على ما تلفظ به، ولا سيما تلك الكلمات القصار التي تنبعث انبعاث السهام وتكشف للناس عن طواياهم، لأن الخطب الفياضة ينسي بعضها بعضا ولا تعلق بالذاكرة.
أخيراً إن على الملوك أن يجعلوا حولهم رجلاً أو رجالاً من أولي الشجاعة العسكرية لقمع الفتن في أوائلها، وبغير ذلك يخشى أن يقع في البلاط عند ابتداء الفتنة مما ينبغي من القلق والإحجام، وتتعرض الحكومة للخطر الذي أشار إليه تاسيتس حيث قال بعد مقتل قلبا Galba بأيدي جنوده “لقد كان قليلون يجسرون على هذه الفعلة، وكثيرون يتمنونها، وجميعهم يرضون بها ويقرونها”.
من اللازم لهؤلاء الرجال أولي الشجاعة الذين يحفون بالملوك أن يكونوا على اطمئنان وسمعة حسنة لا أن يكونوا حزبيين، وأن تعمر الصلة بينهم وبين عظماء الدولة الآخرين، وإلا كان الدواء شر من الداء.
من طرائف وإجابات بيكون نقتطف: فرض القائد الروماني “مارك أنطونيوس” على آسيا الصغرى (تركيا الحالية) ضريبة مضاعفة في السنة، فجاءه سفراؤها يقولون: إنهم على استعداد على أداء الضريبة المضاعفة إذا ما سمح لهم بـخريفين وحصادين في السنة الواحدة.
سيق “بيون” الملحد في بعض الموانئ إلى هيكل إله البحار “نبتون” حيث أروه ألواحاً شتى عليها رسوم أصحاب النذور الذين نجوا من العواصف بالتوسل إلى إله البحار “نبتون”. ثم تحدوه سائلين: وما قولك الآن؟ ألا تعترف الآن بقدرة الآلهة؟ فأسرع مجيباً: بلى ولكني أسألكم: أين أجد الألواح التي يرسم عليها الغرقى من أصحاب النذور؟
روي أن “بيون” خرج في سياحة بحرية فلم يلبث أن هاجت بسفينته الأعاصير، وتعالت أصوات النواتية الذين معه بالدعاء إلى الآلهة وقد كانوا من شرار الناس، فصاح بهم “صه، لا تدعوا الآلهة تعرف بمكانكم في هذه السفينة”.
ختاماً، ترى ما الذي جعل العقاد يقدم للقارئ تلك الأقوال التي استعرضته أعلاه بعد مضي حوالي خمسمائة عام من صدورها؟ وما الذي جعلني أقتبسها لأقدمها لكم اليوم؟ ألا تتفقون معي لأنها أقوال ذات قيمة فكرية وأدبية لم تنقضي بانقضاء مناسبتها ووقتها؟
تضرعاتي بحسن الخلاص؛ وتحياتي.
عبد العظيم ميرغني
 ايكوسودان نت التنمية مستقبلنا
ايكوسودان نت التنمية مستقبلنا