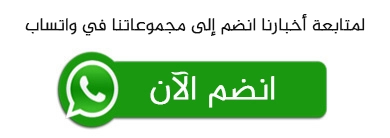طلعت دفع الله عبد الماجد
بصفتي متخصصًا في البيئة والغابات، لفت انتباهي التداخل العميق بين الأدب العربي والسوداني والبيئة الطبيعية. لقد أبدع الشعراء في تصوير الأشجار، مما يعكس فهمًا عميقًا للتنوع البيئي في السودان. هذا التنوع كان محور دراسة هاريسون وجاكسون الشهيرة عام 1958، التي قدّمت تصنيفًا بيئيًا للنباتات في السودان، موثّقةً التحولات من الصحاري الشمالية إلى مناطق السافانا الغنية في الجنوب. وقبل ذلك، أجرى جون سميث، مدير الغابات الاسبق في السودان آنذاك، دراسة نال بها درجة الدكتوراه عام 1949 بعنوان “توزيع أنواع الأشجار في السودان بالنسبة لهطول الأمطار وقوام التربة” ، حيث تناول فيها العلاقة بين توزيع الأشجار والعوامل البيئية المختلفة.
في الشعر السوداني، مثلت الزهور رمزًا للجمال والحنين، ومنحها الشعراء صفات إنسانية تعبّر عن العاطفة والتأمل، كما في أعمال عبد الرحمن الريح. وقد كُتب كثير عن الزهور في الشعر، لكن يركّز هذا المقال على إبراز حضور الأشجار في الشعر العربي والسوداني.
استلهم الشعراء السودانيون من الأشجار رموزًا تعبّر عن الصمود والجمال والارتباط بالأرض، مستمدّين من خصائصها صورًا شعرية تعكس علاقتهم بالبيئة والمجتمع. وقد عبّر كل شاعر عن الأشجار السائدة في منطقته، فتغنّى البعض بالنخيل، وآخرون بالطلح، التبلدي، الهشاب، والدوم. بهذا التوظيف الرمزي، أصبحت الأشجار جزءًا من الوجدان الثقافي السوداني، تتجلّى في القصائد كرمز للحياة والهوية والتجذر في الطبيعة.
الأشجار في “حفنة تمر”: رموزٌ للبيئة والهوية السودانية
في قصة “حفنة تمر” للطيب صالح، تظهر الأشجار كرموز بيئية وثقافية عميقة، تجسّد علاقة الطفولة بالطبيعة والجد. تتكرر الإشارات إلى أشجار كالطلح والسنط والسيال، التي شكّلت جزءًا من المشهد الزراعي والاجتماعي في بيئة الكاتب. هذا التداخل بين الطبيعة والذاكرة يعكس أثر الأشجار في تشكيل الوعي المبكر والهوية الريفية في شمال السودان.
فيما يلي نماذج من أبيات الشعر التي توجه الخطاب إلى أشجار محددة، باعتبارها رموزًا حية تحمل معاني ودلالات بيئية وجمالية.
الطلح:
تُعتبر شجرة الطلح رمزًا للصبر والتحمّل في البيئة الصحراوية القاسية. في قصيدة للشاعر السوداني حيدربي محمد سعيد وغناها (محمد ميرغني)
يا النـــــــــــــازلة…
السمحه بوسط التمر دايماً تفوت…يتـنـّى بي فوقا الجريد…
…
حتى السبيط مدّ الشخاليب وإبتسم…مرات تقيف منو وتشيل…
مرات تفوت مشغولة بي شيتاً كُتـُر…
شدر الطلح رمى البرم…أصفر تحت اقداما مفروش قرمصيص…
يُبرز الشاعر هنا جمال شجرة الطلح وزهورها الصفراء المتساقطة التي تفرش الأرض، مما يعكس ارتباطه العميق بالطبيعة السودانية.
في قصيدة “ضريبة الطلح” للشاعر محمد طه القدال، يتناول الشاعر العلاقة بين الإنسان والأرض، مستخدمًا الطلح كرمز للتجذر والانتماء. يقول القدال في قصيدته:
“يا الطلح في الصحراء… يا ضل الوقف ما انحنى”
يُبرز الشاعر هنا صمود الطلح في وجه الظروف الصعبة، مشبّهًا إياه بالإنسان الذي يظل ثابتًا رغم التحديات.
التبلدي: شجرة الحياة في السودان وآفاقها الواعدة
شجرة التبلدي، معروفة بجذعها الضخم وقدرتها على تخزين المياه، ترمز إلى العطاء والكرم, إن التبلدي ليست فقط شجرة باسقة، بل رمزٌ حيّ للاستدامة والتنوع، وجسرٌ بين العلم والتقاليد، وبين الحقل والبيت. ليست شجرة التبلدي مجرد مَعلم طبيعي في السودان، بل هي كائن حي يتداخل مع تفاصيل البيئة والهوية والمعاش.
وقد وثّق الأخ الصديق بروفيسور يحيى عمر آدم جمعة نتائج مشروع إقليمي حول التبلدي، شاركت فيه مؤسسات بحثية من أفريقيا وأوروبا، وأبرز قيمتها الاقتصادية والطبية. شملت تدريب باحثين، وتطوير منتجات غذائية، والتوصية بإدراجها في برامج التغذية المدرسية. وأكدت الدراسات تفوّق التبلدي السوداني في محتواه من فيتامين C والبروتين، مما يمنحه مكانة مميزة في الأسواق العالمية.
ومن زاوية وجدانية، كتب الأخ الصديق د. الصادق عبد الله في مقالة تأملية بعنوان “تبلديتي” عن تجربة عيشٍ تحت ظلها، حيث تصبح الشجرة بيتًا وطعامًا وذكرى، مؤكدًا على مكانتها الراسخة في وجدان الإنسان السوداني وبيئته.
وقد وثقت لها أغنيات كردفان في الأغنية الشهيرة للدكتور الفنان عبد القادر سالم :
كردفان الصيد فوق قويزو- والتبلدي الشامخ بعزو
يا جمالا نفخر بكنزو- يا حليلا عروس الرمال..
حكاية “تبلديّة الدلنج”: قصيدة وشجرة في ذاكرة المكان
تروي “تبلدية الدلنج” حكاية شجرة غرسها تادرس يعقوب، لقب العائلة الفرشوطي ، وهو رجل مصري الأصل عاش كسوداني محب للعلم والخير. لاحقًا، سكن الشاعر جعفر محمد عثمان خليل في ذات المنزل، وتعلّق بالشجرة التي ظلت حاضرة في ذاكرته، فكتب عنها قصيدته “تبلدية” التي خلّدت الشجرة وجعلتها معلمًا رمزيًا في مدينة الدلنج يتناقل الناس قصتها ويقصدونها بإعجاب. فكانت هذه القصيدة:
ذكرى وفاءٍ وودِّ عندي لبنت التبلدي -في كلّ خفقة قلبٍ وكلّ زفرة وجد
فيا ابنة الروض ماذا جرى لمغناك بعدي؟ مازلتِ وحدك إلفي يا ليتني لك وحدي
هل تذكرين عهوداً قد عشتها في جنابك؟ وهل شـــجـــاك غيــــــابي ؟ إنّي شجٍ لغيابك
الصمغ العربي والهشاب: الجذور اللغوية والمعنى البيئي
يرتبط الصمغ العربي في السودان بشجرة الهشاب، واخيرا أضيفت اليه شجرة الطلح حيث تُنتج الهشاب أحد أنقى وأجود أنواع الصموغ عالميًا، وتُعد رمزًا للمنفعة والصمود. ان مصطلح “الصمغ العربي” عربي أصيل، ورد في المعاجم القديمة، لا كما يُشاع عن أصله الأوروبي. ويرجَّح أن كلمة “عربي” مشتقة من “أربي” في اللغة البجاوية، بمعنى الأبيض النقي، ما يعكس عمق التسمية في البيئة المحلية.
الشاعر السفير احمد الحاردلو كتب هذه الابيات التي تغني بها سيف الجامعة
من اخر الجنوب لي عطبرة وتوتيل -يا شجر الهشاب قوم نمشي نهر النيل
ويا لوز القطن قوم تاني فتح وشيل – وارقص يا نخيل فوق السواقي وميل
وتُستخدم شجرة الهشاب كرمز للمنفعة والصمود. في إحدى القصائد السودانية، لـ اسماء الجنيد يُشار إلى الهشاب بقولها:
“شدر الهشاب… اتشابا لي ضل السحاب
خايف اليباب ..
شدر الهشاب فرهد طرب- من تانى بى عودة الشباب
جدع صميغاتو ورقص..رقصة غريب عاد للوطن بعد الغياب
الدوم:
شجرة الدوم، ذات الثمار المفيدة، تُستخدم في الشعر كرمز للثبات والارتباط بالأرض. في إحدى القصائد السودانية، يُستحضر الدوم للدلالة على الأصالة والعمق في الانتماء.
حيث يقول الشاعر كدكي
جدك كان زمان قرقاشو *** قرقاش كسرى ومرة تمود
جدك عاش زمان الدوكى *** ليها مفجفج الواقود
جدك جيلو كد الدوم *** زمن الدوم حلو ومريود
جدك ماهو ناكر انو *** قروى وفوق برش مولود
جدك ملتزم بالبيئة *** من زمن القرش مقدود
يُشير الشاعر هنا إلى شجرة الدوم كرمز للأصالة والحنين إلى الماضي الجميل.
السيال:
شجرة السيال، المعروفة بأشواكها الحادة، تُستخدم في الشعر كرمز للحماية والقوة. في بيت من قصيدة للشاعر محمد طه القدال، يُشير إلى السيال بقوله:
“سيال وغيم وصلك الراحام”
يُبرز الشاعر هنا السيال كرمز للقوة والصلابة، مشيرًا إلى ارتباطه بالغيم كدلالة على الأمل والتجدد.
السيال في قصائد الشاعر الكبير إبراهيم العبادي من محاسن حسن الطبيعة
ﺷﻮﻑ ﻫﺪﺍﻙ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﻟﺞّ ﺷﺎﺭﻑ .. ﻳﺮﻋﻰ ﻧﺎﻟﻪ ﺍﻟﺤﻮﻝ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭﻑ
ﺍﻭﻋﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻮﺭ ﺳﻴﻠﻪ ﺟﺎﺭﻑ .. ﻣﻴﻞ ﺷﻤﺎﻟﻚ ﻭﺍﺑﺮﻯ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ
ﻋﺞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﻝ ﻇﻠﻪ ﻭﺍﺭﻑ .. ﺩﺍﺋﻰ ﺑﻨﺖ ﺍﻟﺒﺪﻭ ﻭﺍﻧﺖ ﻋﺎﺭﻑ
ﺑﻞ ﺷﻔﺎﻯ ﻣﻦ ﺩﺍﺋﻰ ﺍﻟﻌﻀﺎﻝ
السنط
ابيات من قصيدة ام بادر للشاعر الناصر قريب الله والتي تغني بها الكابلي
كم لوادي الوكيل عندي ذكرى …زادها جِدّة مرور الليالِ
وفتاة لقيتها، ثَمّ تجني ثمر السنط في انفراد الغزالِ
تمنح الغصن أسفلي قدميها ويداها -في صدر آخر عالِ
يقول د. الصادق عبد الله لقد وثقت أغنية شعبية لشجر الدُباغ (السنط) الذي تدبغ بثماره الجلود:
فرع الدباغ الهش، يالشايل الشبش..
بريدك ريد مو غش.. يا ديف أمات ربش.
وأغنية للبنات في وقتنا تقول بعض كلماتها:
يا فريع القرض .. سببت لينا المرض ..
يسلـم القصاري .. سهاوي عام البلد.
الدليب في شعر صلاح أحمد إبراهيم
بالله .. بالله يا الطير المهاجر للوطن زمن الخريف- تطير بسراع تطير ما تضيع زمن
اوعك تقيف وتواصل الليل بالصباح- تحت المطر.. وسط الرياح
وكان تعب منك جناح …. فى السرعة زيد – فى بلادنا ترتاح
ضل الدليب- اريح سكن
اللبخ
من الأغاني الشعبية التي ارتبطت بذاكرة “لبخة بارا” و”محكمة زانوق”، تلك التي تغنت بوسامة وهيبة السيد أمين سيد أحمد قريش، كاتب المحكمة آنذاك، والتي تقول: “الغالي تمر السوق.. كان قسموه ما بحوق.. زولاً سنونو بروق.. في محكمة زانوق”. صاغتها الفتيات تعبيراً عن إعجابهن، وظلّت تتردد كترنيمة شعبية تعبّر عن الافتتان.
شجرة الحراز
تُعد شجرة الحراز رمزًا بيئيًا وثقافيًا فريدًا في السودان؛ إذ تفقد أوراقها مع بداية المطر، مما يسمح بزراعتها مع المحاصيل، وتكتسي خضرة في موسم الجفاف فتوفّر الظل والمرعى. تجاوزت رمزية الحراز بعدها الطبيعي لتغدو استعارةً في الثقافة السودانية للدلالة على الجفاء والقطيعة، كما في المثل: “ما بيني وبين فلان ما بين الحراز والمطر”. وقد استلهم الشعراء هذا المعنى، فجعلوا من الحراز رمزًا للفُرقة، ومن تصالحها مع المطر أملاً في عودة الوصال بعد الانقطاع.
فيقول:
“قوم يا حراز وادخل مكان كل اشتهاءاتك مجرتقه بالفرح
قوم يا حراز- ورقك هويتك وانتماءك
خلي المطر ينزل عليك واكبر عليه- راقد على رمل الضفاف والنيل رحل”
وتحوّلت هذه القصيدة لاحقًا إلى لحنٍ خالد، حين اختارها الفنان السوداني الراحل مصطفى سيد أحمد، فأنشدها بصوته العذب، لتغدو واحدة من أجمل أغنياته وأكثرها مساسًا بالوجدان. حيث تقول كلماتها:
“صُدْ لى ملامحك يا حراز – ريح العوارِض … غرّبتْ
فرتِق ضفايرك .. فى الرزاز- جية العصافير”
شجرة البان
حظيت شجرة البان بمكانة رمزية في الشعر السوداني والعربي، حيث استخدمت للدلالة على الجمال والأنوثة والرشاقة. فقد شبّه الشعراء قوام المحبوبة بفرع البان لما تتميز به الشجرة من ليونة وتمايل، خاصة في أغاني الحقيبة السودانية.
حيث قال الشريف الرضي
يا ظبية البان ترعى في خمائله ليهنك اليوم أَن القلب مرعاك
الشاعر محمد ود الرضى
السلام يا روح البدن – يا غصين النقا يا لدن
يا مهفهف يا املدن – ليك غصون البان قلدن
ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ, يا بهجة حياتي
ﺷﻔﺖ ﺍﻟﺒﺎﻥ ﻣﻤﻴﻞ ﺗﺤﺘﻮ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﻣﻘﻴﻞ- ﻳﺎ ﺩﻣﻌﻲ ﺍﻟﻤﺴﻴﻞ ﻭﻟﻴﻚ ﺛﻐﺮﺍ ﻳﻤﻴﻞ
يا أم جمالاً يشفى السقيم -سيد عبد العزيز
يا الجويهله وقدرك عظيم- حسنك أبدع عن ما إتروى
زى سناك الدر النظيم -يا فريع البان الروى
قصيدة جبل مرة للراحل عبد الكريم الكابلي
كان الشاعر والأديب والفنان المبدع الراحل عبد الكريم الكابلي في زيارة إلى جبل مرة، حيث تُوجد فيه تنوّعات نباتية مدهشة، من بينها 28 صنفًا من أشجار البان، إضافة إلى السرو والصنوبر. رافقه في الرحلة الفنان أبو عركي البخيت وآخرون، وكانوا ضيوفًا على زميلنا الراحل عبد الرحمن قرشي، مساعد محافظ الغابات آنذاك، في استراحة الغابات في قلول. وخلال تجوالهم في غابات المنطقة، ألهمهم جمال المكان، فقام الكابلي في حينها بتأليف وتلحين قصيدة “جبل مرة”، التي أهداها إلى أبو عركي، لتصبح لاحقًا من أجمل الأغاني التي تغنى بها.
زهر ريان نادي وبسام- بالحيل داير ريشة رسام
جيرانه جداول هيمامة- وصنوبرة نادية وريانة
وزمردة في صورة بانة
تغنى محمد وردي أيضا لصديق أحمد بأغنية “البانة” وقد تجاوب جمهور وردي وصفّق على إيقاع الدليب بصورة مدهشة، في تسجيل مبذول على اليوتيوب..
“ﺯﻱ ﺍﻟﺒﺎﻧﺔ ﻣﻴّﺎﻟﺔ – ﻳﺎ ﻧﺎﺱ ﺻﻠﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﺎﻟﺎ
ﺩﻟّﺖ إﻳﺪا ﻭﻣﺎﻟﺖ ﺷﻤﺎﻟﺎ – ﻭﻣﻴّﻠﺖ ﺍﻟﺤﻔﻠﺔ ﺑﻲ ﺣﺎﻟﺎ
ﻳﺎ ﻧﺎﺱ ﺻﻠﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﺎﻟﺎ – ﺍﻟﺮﺳﻮل.. ﺍﻟﻨﺒﻲ
صفقولا شديد يا زمالة – أوعكم من عينا ونبالا”
فريع البان للشاعر الأمين ود الأمين ( ود آمنة)
من فريع البان اليسوح نديان
منه ياسلام
البان في شعر صالح عبد السيد أبو صلاح
فريع البانة المن نسمة
يتمايل حاكى المنقسمة
البان في كلمات ابوصلاح وألحان كرومة
ما بصح ليك يا فلان طرفك دوام ناعس وأنا طرفي ما غفلان
أظهرت شكلك بان كوكب منير أشرق من فوق لي غصن البان
الندامة
هذه الأبيات جزء من أغنية “الندامة”، التي أداها الفنان الخير عثمان. هناك اختلاف حول مؤلف هذه الأغنية، حيث تُنسب في بعض المصادر إلى الشاعر حسن دراوي، وفي مصادر أخرى إلى الشاعر محمد عثمان عبد الرحيم. نظرًا لهذا التباين، لا يمكن الجزم بنسبة الأبيات إلى شاعر محدد.
أيها الرافل فى مجدٍ من الحسن دواما- ماست الأغصان لما عشقت منك القواما
تتحدى البانا ميلا وإعتدالا وإنقساما- وتفوق البدر حسنا وضياء ووسامة
من الرمز إلى الوعي البيئي: قراءة ثقافية وعلمية في مكانة الأشجار
في الثقافة السودانية، تتجاوز الشجرة كونها عنصراً طبيعياً لتُصبح كائناً حيّاً ينبض بالمعنى والرمز. فهي ظلّ في الهجير، ومصدر للعطاء، ومكان للذاكرة، واللقاء. انعكست مكانتها في أسماء الأمكنة، واللغة الشعبية، والعادات، وجعلت منها رمزاً للثبات والانتماء. وتُعد الشجرة في هذا السياق جزءاً من الهوية الثقافية، حاضرة في الشعر والحكاية، وشاهداً على الصلة العميقة بين الإنسان وبيئته.
الاراك والسيسبان والسلم والتمر- قصيدة “القمر بوبا عليك تقيل -إسماعيل حسن
الصغيرة شجيرة الأراك- يا قمر عشرة الفي سماك
شاغلة روحي وقلبي المعاك- ويمضي الشاعر في الوصف
الغزال الفوق في السلم- المحبة تزيد الألم
كل يوم أصبح لي في هم- سيسبان عودك منظم
التميرة الفي سبيطتا-الصفار صابغ خدرتها
نخيل التمر في حب الاديم- مبارك المغربي
من مناظر السبر صفحة -من رهيدي البردي لوحة
من نخيل الباوقة طرحة- من مريدي السمحة نفحة
لن احيد الشاعر محي الدين فارس- النخل والصفصاف والسيال
ونسير فوق جماجم الأسياد مرفوعي البنود- تزغرد الجارات والأطفال ترقص والصغار
والنخل والصفصاف والسيال زاهية الثمار- وسنابل القمح المنور في الحقول وفي الديار
الطلح والخيزران والسيسبان في شعر: *محمد المكي ابراهيم*
في غابة الطلح أو غابة الخيزران- نبهيني إذا أزهر السيسبان
وإذا ظلل الغيم سهب البطانة- ألقى قذيفته السندسية في كردفان
السنط والسدر-مساجلات خليل فرح في الدوباي مع شعراء زمانه ومنهم الفنان عمر البنا
وكان البنا قد ارتجل:
شوف بالله شوف تلك الغصون الخضر
في الميلان تشابه الرافله داخل الخدر
ورد خليل فرح وبسرعة وبديهة حاضرة في اللحظة بـ:
تحت خميلة من شجر السنط والسدر
تتفجر ينابيع الحياة وتجري, تتمايل غصونها كمثملات الفجر
النيم والابنوس والبان بكائية الشاعر محجوب شريف
مرت الأشجار كالخيال أحلام
ناس لطاف وظراف مابين غزال وزراف
مابين ظلال وغمام مرت الأشجار
والنيمه ذات الساق القدره كم تشتاق
ابنوسة اللاوو ياحليلا غصن البان
محجوب شريف جميلة ومستحيلة
ﺣﺪّﺛﺖ ﻋﻨﻚ ﻧﺠﻤﺔ ﺟﺎﺭﺓ, ﻭﺯﺭﻋﺖ ﺍﺳﻤﻚ.. ﺣﺎﺭﺓ ﺣﺎﺭﺓ, ﻓﻰ ﻣﻨﺎﺩﻳﻞ ﺍﻟﻌﺬﺍﺭﻯ, ﻓﻰ ﻣﺸﺎﻭﻳﺮ ﺍﻟﺤﻴﺎﺭﻯ, ﻓﻰ ﻟﺤﺎ ﺍﻷﺷﺠﺎﺭ ﻛﺘﺒﺘﻪ ..ﻧﺤﺘﻪ ﻓﻰ ﺻﻢ ﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓ
التنوع الأحيائي في الثقافة السودانية
يبرز د. يوسف محمد أحمد إدريس أثر التنوع الأحيائي في الثقافة السودانية من خلال الأسماء والشعر الشعبي، حيث تعكس أسماء الأشخاص والقرى ارتباطًا وثيقًا بالنباتات والحيوانات المحلية. ويُجسّد شعر البادية هذا الارتباط، موثقًا البيئة ومعالمها بكل ما تحمله من نباتات وحيوانات. وقد ورد في أشعار الحردلو، كـ”مسدار الصيد”، ذكر لأنواع نباتية عديدة مثل السيال، الطلح، السدر، والنال. هذا التوظيف الشعري يعكس وعيًا بيئيًا عميقًا متجذرًا في الثقافة السودانية.
التنوع الأحيائي في أوپريت الشريف الهندي: حين يُغنّي النباتُ والحيوان
يتجلّى الاحتفاء بالتنوع الأحيائي – النباتي والحيواني – في أوپريت الراحل الشريف زين العابدين الهندي، ولحنه وأدّاه بصوت خاشع طروب الفنان المبدع الراحل عبد الكريم الكابلي. ففي هذا العمل الغنائي الوطني، تتناثر الإشارات إلى الأنواع البرية والنباتات المحلية، في انسجام شعري يُجسّد الارتباط العميق بين الإنسان السوداني وبيئته، ويُبرز حضور الطبيعة كجزء أصيل من الهوية الثقافية والغنائية.
تيلادك مسكر في الخزن محروس-هجليج واندراب ومهوقني وابنوس
ومن صمغ الهشاب سوي السنط ترتوس- ومن شدر التبلدي الموية كوس في كوس
ومن ضل النخيل الشمس دايرة تكوس- ومن حرب المطر فرع الحراز مدروس
ومن شوك السدر جيش السلم هكسوس- ومن زهر التبر البادية باقية عروس
وبي توب البرم سوي الطلح مبلوس- ومن شدر الاراك عطر الرعاش مبثوث
ومن سيف العشر جيش هكس صار مهروس- والدوم واجي بي قيف الابتراوي خروس
الأشجار في شعر قاسم الحاج – لو اعيش زول ليهو قيمة
لو اعيش طول عمري نسمه.. او مع الايام سحابه
اهطل ادى الدنيا بسمه.. أروي وادى واسقى غابه
لو اعلم طفل واعد.. لسه ما عرف الكتابة
وأبقى شجره ظلالها وارفه.. تحتى ناس نايمين تعابه
الأشجار في شعر عبد الرحمن الريح
في المقرن تشوف الأشجار صفوف -والنيل حولها كالعابد يطوف
وكتب عن توتي
حسبتنا مكتملة ننزل هناك جملة- نمشي في الرملة ونجلس في شاطينا.
جلسنا تحت أشجار متفتحة الأزهار- وصوت السواقي نهار نغماته تشجينا.
الأشجار في شعر ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺣﻤﻴﺪ
ﻳﺎ ﻃﺎﻟﻊ ﺍﻟﺸﺠﺮﺓ, ﺟﻴﺐ ﻟﻲ ﻣﻌﺎﻙ ﻭﻃﻦ, ﺍﻟﺠﺄ ﻟﻮ ﻳﺎﻭﻳﻨﻲ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺧﻮﻑ ﻭﺣﺰﻥ
ﻟﻠﻔﺎﺗﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺷﺠﺎﺭ, ﻭﺍﻗﻔﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻢ ﺭﻭﻕ, ﺑﻲ ﻋﺸﻮ ﻋﺼﻔﺖ ﺭﻳﺢ, ﺭﻳﺢ ﺍﻟﻤﺤﻦ ﻭﺍﻟﻌﻮﻕ
الأشجار في شعر عبيد عبد الرحمن
أنا يا طير..أنا يا طير بشوفك, أنا يا طير. محل ما تطير بشوفك
وفي الاشجار نقيل وفي الأغصان نميل
الأشجار في شعر الدوبيت
سلّط الشاعر والقاضي والمحامي والصحفي والباحث في الادب الشعبي الراحل أسعد الطيب العباسي الضوء على حضور الأشجار في شعر الدوبيت، مستعرضًا نموذجًا من شعر “حسان ود عوض الكريم” الذي أشار إلى أشجار مثل اليوى والسنط في رباعياته. وفي إحدى قصائده التي نظمها بسنار، عبّر عن حنينه للبطانة مستخدمًا مفردات نباتية ذات دلالات بيئية وشاعرية، مما يعكس العلاقة الوثيقة بين الشاعر والبيئة الطبيعية في أدب الدوبيت.
نماذج من الشعر العربي عن الأشجار
يا نائح الطلح”
لأمير الشعراء أحمد شوقي، معارضا نونية إبن زيدون
يا نائـح الطلحِ أشباهٌ عواديـنا … نشْجى لواديـك أم نأسى لواديـنا
ماذا تـقصُّ عليـنا غيرَ أنّ يـداً … قصـَّـتَ جـناحك جالت في حواشينا
وتغنّى العرب في أشعارهم بالنخيل كثيرا وعدّوه أمير الحقول وطعام الغني والفقير، وزاد المسافر والمغترب كما في قصيدة أحمد شوقي الطويلة التي قالها في وصف النخيل وذكر مناقبه، ومن ضمنها يقول:
أهذا هو النخلُ ملكُ الرياضِ- أَميرُ الحقولِ، عروسُ العزب
طعامُ الفقيرِ، وحَلوَى الغَنيِّ- وزادُ المسافِر والمُغْتَرِب
ابيات للشاعر لبيد بن ربيعة في الأشجار (لبید بن ربیعة بن مالك بن جعفر بن كلاب بن ربیعة بن عامر بن صعصعة بـن معاویـة بـن بكـر بـن هـوزان بـن منـصور بـن عكرمـة بـن خفـة بـن قـیس بـن غیلان بن مضر)
سُحُقٌ يَمْنَعُها الصَّفا وسَرِيَّةٌ- عَمَّ نَواعِمَ بَيْنَهُنَّ كُرُومُ
في هذا البيت، يشبّه لبيد النوق الطويلة بالنخيل الباسقة، حيث تشير كلمة “سُحُقٌ” إلى النخيل الطويلة، و”كُرُومُ” إلى الأشجار المتشابكة الأغصان.
هَوَى غُدافٍ هَيَّجَتْهُ جَنُوبُهُ- حَثِيثًا إلى أَذْرَاءَ طَلْحٍ وتَنْضُبِ
يصف في هذا البيت طائر الغداف الذي دفعته الرياح الجنوبية نحو أشجار الطلح والتنضب.
كَأَنَّ أَظْعانَهُمْ في الصُّبْحِ غادِيَةً- طَلْحَ السَّلائِلِ وَسْطَ الرَّوْضِ أَوْ عَشَرَا
يشبّه النساء الراحلات في الصباح بأشجار الطلح أو العشر في وسط الروض.
تَخَيَّرَ ما بَيْنَ الرِّجامِ وَواسِطٍ- إلى سِدْرَةِ الرَّسِّينِ تَرْعَى السَّلائِلَا
يتحدث عن التنقل بين الأماكن، مشيرًا إلى شجرة السدر في منطقة الرسين حيث ترعى الإبل.
حُفِزَتْ وَزايَلَهَا السَّرابُ كَأَنَّهَا- أَجْزاعُ بِيشَةٍ أَثْلُهَا وَرِضامُهَا
يشبّه الإبل المسرعة التي يزول عنها السراب بجذوع أشجار الأثل في وادي بيشة.
فَباتَ كَأَنَّهُ قاضِي نُذُورٍ- يَلُوذُ بِغَرْقَدٍ خَضِلٍ وَضَالِ
يشبّه شخصًا يلوذ بأشجار الغرقد والضال كما يفعل قاضي النذور.
هذه الأبيات تؤكد استخدام لبيد بن ربيعة للأشجار والنباتات في تصويره الشعري، وتظهر في مصادر متعددة مثل “معلقة لبيد بن ربيعة” و”شرح المعلقات السبع للزوزني
الأشجار في شعر الراحل بروفسير عبد الله الطيب
في ديوان أصداء النيل للبروفسير عبد الله الطيب، تتجلّى الأشجار السودانية مثل السنط، السيّال، الطلح، والسدر بوصف شعري عميق يعكس البيئة المحلية ويستدعي التراث والوجدان الجمعي. فهذه الأشجار لم تكن مجرد خلفية طبيعية، بل أصبحت أصداءً للنيل وصوتًا للطبيعة السودانية التي عايشها الشاعر.
السنط:
ظهرت أشجار السنط في شعر عبد الله الطيب كغابة تحفّ النيل، تُرفرف أغصانها كأنها أرواح حية تنسجم مع النسيم، في صورة نابضة بالحركة والعذوبة.
والنيل تحتَك منساب مرفرفةٍ- عليه من عذبات السنطِ أغصانُ
وفي ابيات اخري
والسنط مشتملٌ بالنورِ خافقةٌ – أغصانُهُ والنسيمُ الغضُّ هبّابُ
وبين السنط في الاسمال شعث دلفن مع العشية لاحتطاب
حيث يذهب بنات القري للاحتطاب من شجر السنط لاستعماله في وقود الطهي عليهن ملابس خرقة ورؤوسهن مغبرة مشعثه
السيّال: أضفى الشاعر على شوك السيال لمعانًا ساحرًا، يشبه ذرّات الضوء في السراب، ليُجسّد بها مشهدًا صحراويًا آسرًا، يفيض بالحياة رغم قساوة الطبيعة.
وشوكُ السيالِ يلمَعُ النورُ فوقَهُ- طرائقَ مثلَ الذرِّ يلمَعُ في السرابِ
السدر: جاءت السدر في صورته الشعرية أنثوية نضرة، محمّلة بالبرعم والعطر، رمزًا للجاذبية والرقة، تحرّك المشاعر كما تحرّكها الزهور التي تُقطف بين الأشواك.
ألا تُعجبكِ السِّدرَةُ ذاتُ النبق الداني
الطلح: استخدم الطلح كتعبير عن مشهد جبلي مهيب، حيث جعله في صورته الشعرية “دخانًا يتصاعد من المدخنة”، مجسّدًا اندماج الشجرة بالفضاء والذاكرة والمكان.
والجبلُ السّامي المُطِلُّ على الوادي الّذي حَلَّهُ بَنو حَسَنَهْ- مُتَوَّجٌ بالسَّحابِ مِثلُ دُخانِ الطَّلحِ قدْ عَجَّ حولَ مِدخَنَهْ
نُشير هنا إلى ضرورة مراعاة الأمانة العلمية والأدبية، حيث اعتمدنا في هذا التوثيق على جهود عدد من المهتمين والباحثين في شعر الحقيبة والدوبيت السوداني، من بينهم ميرغني ديشاب، الذي تناول إيقاعات النوبيين ولغاتهم في المشهد الثقافي السوداني وأسعد الطيب العباسي، ومرتضى الغالي، وتاج السر عثمان بابو، و د. يوسف محمد أحمد وازهري الحاج بشير وغيرهم، عبر ما نُشر في منصات مثل “سوادنايل”، و”الراكوبة”، المنتديات المختلفة وغيرها من المواقع الاجتماعية. كما نلفت إلى احتمال ورود بعض الاختلالات اللغوية أو العروضية في الأبيات المنقولة التي قد تحتاج الي تصحيح او تعديل او تنقيح، نظراً لتداولها الشفهي أو النصي عبر أوساط متعددة من محبي هذا التراث.
خالص الشكر والتقدير لأخي وزميلي، الأديب الأريب والمهندس الزراعي الأستاذ محمد حسن خضر، من ادباء فداسي، الذي تفضل مشكورًا بإبداء ملاحظاته القيّمة على هذه المقالة.
كما أخصّ بالشكر والتقدير الأخ البروفيسور حسان بشير حسان حامد، أستاذ الأدب والنقد بكلية اللغات – جامعة بحري، لتفضّله بإرسال مقاله القيّم المنشور في مجلة كلية الآداب بجامعة أم درمان الإسلامية بعنوان: “البيئة السودانية في شعر عبد الله الطيب: موضوعاتها وخصائصها الفنية”. وقد شكّل مقاله إضافة نوعية، بما تضمّنه من تحليل رفيع أضفى عمقًا فكريًا وأدبيًا.
أود أن أعرب عن خالص امتناني وتقديري لصديقي وزميلي، البروفيسور حيدر إسماعيل، أستاذ الطب البيطري بجامعة بحري، على مساهمته القيّمة في تسليط الضوء على الشاعر تادرس يعقوب الفرشوطي. أوضح البروفيسور حيدر أن لقب عائلة الشاعر هو “الفرشوطي”، وأنه كان جارًا لهم في حي الخرطوم غرب. كما أشار إلى أن الشاعر تادرس يعقوب الفرشوطي هو مؤلف القصيدة الشهيرة “فرحة العيد”، التي كانت جزءًا من منهج المحفوظات للمرحلة الابتدائية في السودان. تبدأ القصيدة بالبيت: “يا فرحة العيد جوبي أرض وادينا، وباركي أهله السمر الميامينا”.
 ايكوسودان نت التنمية مستقبلنا
ايكوسودان نت التنمية مستقبلنا